
قراءة نقدية لكتاب الدكتور حسن عبد الله : دمعة ووردة على خدِّ رام الله
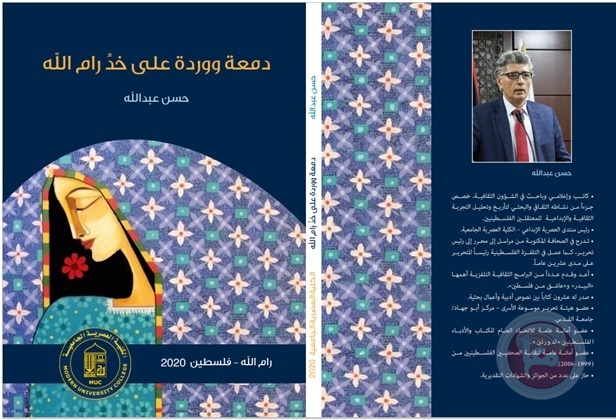
الكاتب: د. روحي ثروت زيادة
ها هو الكاتب والأديب الدكتور حسن عبدالله يطل علينا بعمله الجديد، دمعة ووردة على خد رام الله، إصدار الكلية العصرية الجامعية، أنتجه في زمن الحجر من كورونا؛ أي في زمن قصير، أنتجت قريحته الأدبية مجموعة من القصص القصيرة، أبدع فيها كاتبنا أيّ إبداع، ففي كل قصة تراه يمسك بعناصر القصة، يتفنن في توظيفها توظيفاً أدبياً موفقاً، واللافت في هذه المجموعة القصصية هو تركيز الكاتب على جميع العناصر بنفس الوتيرة، فلا يطغى عنصر على عنصر آخر؛ فتراه مسكوناً بالمكان عاشقاً له، وفي نفس الوقت يقلب صفحات الزمان، يتذكر الماضي الجميل بجميع تفاصيله، ويحن لأيام مضت، لكن ذكراها تربعت في قلبه كما الدم الذي يجري في عروقه، ويستحضر الحاضر، راضياً غير متذمر، متصالحاً مع ذاته وحاضره، وفي نفس الوقت يتوق لمستقبل أجمل، أما أشخاص قصصه وشخوصها، فهم حقيقيون ذكَرَهم بأسمائهم، وإن دلَّ هذا على شيء فإنما يدلُّ على الحب الذي يسكن قلبه تجاههم، وكعادته ينصهر الدكتور حسن عبد الله في المكان، يعشق الأطلال، يعشق البيوت القديمة، يعشق الزقاق، في رام الله القديمة، وفي بيت لحم، ونابلس، ودمشق، ووجدة المغربية، يستنشق عبق الماضي الجميل فيها، يحب رائحة الماضي التليد التي تفوح منه، وتكرار ذكر الأمكنة لديه بشكل لازمة يطرب لسماعها، فلا يمل من ذكرها، كيف لا وهو مجبولٌ على حب هذا المكان أو ذاك؛ لأن جمال المكان عنده مرتبط بتلك الذكريات وذاك الحنين، وتلك الأماني التي طالما حلم بها شاباً، وبذكائه، تجده إن شعر أن المكان قد غاب وتوارى، يعيدك إليه تارةً أخرى؛ لأن المكان عنده مقدس، وجدلية المكان مع الشخوص، والتي انسابت في هذا العمل الأدبي بشكل تلقائي مع ميل للشكل العادي الذي يظهر فيه أثر الزمان المعين على منطقة جغرافية وسكانية معينة.
وأما شخصيات قصصه وشخوصه فهي ليست مسطحة، ولا يتناول الشخصية بوصف عادي؛ بل تراه يغوص في أعماق الشخصية، ويستخرج أجمل ما فيها من لآلئ ودرر، فهو يبدأ الغوص الفني في دواخل الشخصيات، فيعالج أحلامها، وآمالها، وآلامها، ومخاوفها، ويكشف تناقضاتها بدربة فنية مذهلة. وبالحوار الذي يجيده إجادة متفردة، فحينما تناول بستان المهندس سامر الشيوخي، لم يتوقف عند حدود ظاهرة؛ بل صور شخصية المهندس سامر، وما تحمله نفسه من اشتياق وحنين لبستانه في خِضّم انشغاله بتيسير أمور الكلية العصرية في ظل كورونا، واهتمامه الكبير بمتابعة كل تفاصيل العملية التعليمية عن بعد، والحِرص على تقديم أفضل ما يمكن تقديمه، ولكن نفسه متعلقة بالبستان الجميل الذي يعشقه، ويرتاح في أحضانه، نوازع عميقة تزاحمت في نفس المهندس سامر، فحب العمل، وحب العلم، وحب البستان. حتى إنه أنطق كل موجودات البستان من شجر وحجر، حتى فرحت واستبشرت بزيارة المهندس سامر لها، وأحسّت به وبفرحه وتبسمت للقائه. وحينما تحدث عن جهاد صالح الكاتب والأديب اكتشف جهاد الطفل المولود في لحظة الضياع، على صخرة ما زالت شامخة ، رابضة في مكانها، لتحكي له حزناً مضى؛ لكنه لم ينقضِ شكلت تلك الصخرة شخصية جهاد صالح المجبولة بالحزن والفرح، والغربة والوطن، يدخل في أعماق نفس جهاد ليستخرج أجمل ما يحب الصديق من صديقه. أما الألم الذي عانى منه الكاتب من ضرسه أيام الحجر، ليس ألماً عابراً، هو ألم مُزمن منذ كان أسيراً ومعتقلاً، مذ كان شاباً، في الماضي في المعتقل كان ألم ضرسه يحوّل حياته إلى جحيم، أما اليوم، فالألم هو الألم؛ لأنّ هناك أملاً في زيارة عيادة ابنته في القدس، ثمرة إيمانه وعطائه، هذا الأمل خفف من شدة الألم، وأعاد إلى نفسه ذكرى الألم في المعتقل ليكتشف بنفسه المفارقة بين الألمين. أما صديقه إبراهيم جوهر وزميل دراسته، فهو إنسان غير عادي؛ لكنه يشبهه في المعاناة، تقاسم معه ثمن الكتاب، وتقاسم معه الشعور بالبرد والجوع، فلم يجد كاتبنا فرقاً واحداً يجعله مُختلفاً عن صديقه إبراهيم جوهر، ووظف وصية جوهر أجمل توظيف فقد أنجبت من رحمها شعراء وروائيين، تحكمهم نفس الظروف. وفي قصة دوار الساعة والمنارة، أدار الكاتب عبد الله مونولوجاً فاق الخيال حينما دخل قاعة المربية هيام ناصر، وبدأ يتسلل لسمعه كثير مما قيل في هذه القاعة ضمن نشاطات الكلية العصرية، فأنطق كل موجوداتها، فالتهبت مشاعره بين الشوق والحنين، والحزن على صديقه (أبو عباية) وطفلته حنان التي كبرت بينما كان أبوها يقبع في الاعتقال. وأما عنصر الحوار فقد وزّع كاتبنا الأدوار بذكاء وحنكة، وجعل ينتقل بين ممرات الأحداث بحذر شديد، كي لا تفوته ذكرى هنا أو هناك، أو يغفل عن تذكر لحظة فرح أو حزن، والحوار الخارجي في قصصه حوار هادف، يرسل من خلاله رسائل وُدٍ ومحبة، أما المونولوج (حديث النفس) فيا له من إبداع، حتى الصمت الجارح في جميع أماكن القصص أنطقه، فخرج من الصمت ضجيج وهتافات وزغاريد، فما أشبه اليوم بالبارحة مع اختلاف العناوين، بالأمس أسرٌ واعتقال وعوز، واليوم وباء وضياع واختلاف. وبين هذا وذاك لم ينسَ أن النفس تملّ الجمود، فأبدع في تغيير أسلوبه، متنقلاً من الحنين والحزن إلى الترويح عن نفس القارئ، فأدخل عنصر الفكاهة البعيد عن السخرية، في قصته مراسم استقبال بطيخة، وضمنها ذكريات قديمة، منذ طفولته جاءت نفسها قصصاً منفصلة؛ لكنها مرتبطة مع مراسم استقبال البطيخة في زمن كورونا. فالبطيخة التي اشتراها وزميله في الدراسة والسكن من بيت ساحور، والبطيخة التي أكلها من حقل الحاجّة أم ...، والبطيخة في المعتقل، كلها توصل إلى محطة واحدة، هي الأمل في البقاء والحياة في كرامة، وعفوية الكاتب هنا لم تغب عن قلمه، فكانت الفكاهة النابعة من العفوية بطعم الذكريات العذبة أجمل ما يكتب إنسان. أما اللغة ، فكانت مباشرة في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التصريح، وكانت رمزية موسيقية أشبه بقصيدة شعرية تُعزف لها الألحان من أجمل الآلات الموسيقية، وتصدح بها حناجر المطربين، فقد وظف عبد الله لغة شعرية رمزية تارة، وألفاظاً بجرس عالٍ في أماكن أخرى، فقد وظف أديبنا اللغة بجميع مستوياتها، وجاءت لغته كالعجينة اللينة، يخلق منها المؤلف صوراً إبداعية دقيقة التصوير والإثارة..لغة الإيقاع السريع الموجز، المتتالي الإيقاع . وتلمح كذلك من كتاباته توظيف الأسطورة بشكل واضح، خاصة حينما يصف المكان وما حل به بفعل الزمان، فقوة الزمن التدميرية التي حلَّت بقصصه، تحمل معاني أسطورية، وتوحي بمعتقدات، لا أقول دينية فحسب؛ بل وطنية وسياسية واجتماعية، فجمع بين التاريخ والأسطورة والواقع والفانتازيا.
وإن هذه المجموعة القصصية قدمت رؤيا ثاقبة، شكلت البديل الموضوعي لحالة القلق، والخوف والحذر التي رافقت زمن الحجر للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تعرضت المجموعة لتشريحها وتحليل تداعياتها بعمق، وإن الكاتب استطاع بالفعل أن يلتقط خيط الضوء النحيل، وبصيص الأمل في حالك العتمة التي غطت كل شيء.
فكان كاتبنا نفسه، ولم يقلد أحداً من السابقين، ووظف كل إمكاناته لما كتب ببراعة وذكاء وحسن أداء. وهو بهذا ميز نفسه عن غيره، وما كان ظلاً لأحد.
ويوظف الأديب والقاص حسن عبد الله العفوية الطاغية في قصصه، عفوية التراكم والحوار ولحظات الاكتشاف والإضاءة وسلاسة النسق الفلسطيني، وروائح الأحداث والأمكنة والشخوص والألوان والطرق، ضمن مزيج فني ذي اقتدار بالغ الدقة.
ويطغى عنصر التشويق فيها حيث إن قراءة المجموعة لا تجلب الملل، على الرغم من أن مواضيعها مختلفة ومتباينة، فقد أوجد فيها نكهة غير معهودة، وإبداعاً متميزاً، انعكس في الشكل والقص والرؤيا والمعالجة. وعلى المستوى الفني، قدم شخصياته بشكل جعلها تتحرك أمام القارئ، يتصورها إلى درجة الوضوح، حية نابضة بكل التناقضات المكانية والزمانية، إلى جانب توظيفه التراث الشعبي ومفرداته توظيفاً ذكياً جعل القصص تتجاوز محليتها إلى آفاق أرحب وأشمل.
وأخيراً وليس آخراً، ليس من باب المجاملة أقول؛ بل من أوسع أبواب النقد الأدبي، وبكل صراحة هذا العمل الأدبي تكلل بالنجاح بجميع عناصره، وهذا لا يعني الكمال، فالكمال لله وحده؛ ولكنه يعني النجاح والمثابرة. أما وإن كان لا بُد من ذكر بعض الملاحظات على هذا العمل، فلم أجد سوى ملاحظتين هما، أولاً: الاستطراد الكثير في القصص، مع الاعتراف بقدرة الكاتب على مسك أطرافها، فهو وإن شت عن موضوع تبقى ثنياه باليد، ويعلم إلى أين سيذهب بك، وإلى أين سيعيدك. ثانياً: الأسلوب المباشر في الوصف أحياناً، فتراه أحياناً يتحدث عن الأشياء بطبيعتها وأوصافها الخارجية، ولعله الموقف ذاته يفرض أحياناً على الكاتب هذا الأسلوب.