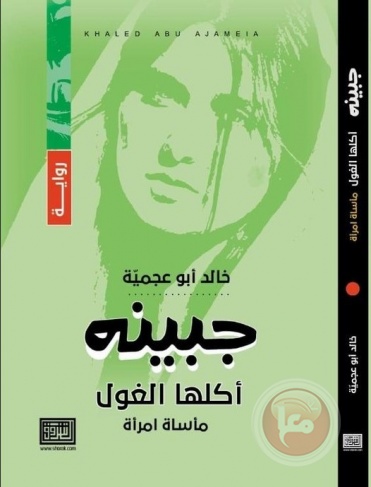
الكاتب: حسن عبدالله
من شأن أي عمل أدبي خاصة إذا كان عملاً روائياً أن يثير أسئلة وتداعيات في ذهن القارئ، حيث تتباين هذه الأسئلة لغة ومضموناً، انطلاقاً من المستوى الثقافي والفكري للقارئ، وفي المقابل فإن أي عمل أدبي لا يثير أسئلة ولا يلامس مساحات حساسة، سوف يقتصر على أن يكون رقماً جديداً في الإصدارات دون أن يتحول إلى إصدار نوعي.
رواية "جبينه أكلها الغول مأساة – امرأة" للروائي خالد أبو عجمية، كنت أفضل ألا تضاف "مأساة أمرأة" للعنوان، لعدم الوقوع في إشكالية الإطالة، أو لئلا نضع تفسيراً للعنوان من خلال العنوان ذاته، بيد أن ما جاء بين دفتي الكتاب من سرد وحوار وصور معبرة عن الأفكار والمضامين جعلني استبعد الإصدار الكمي وأنحاز لتصنيف الرواية بإصدار نوعي، لأنها حملت أسئلة قلقة ومعطيات صادمة.
سأحاول في مقالتي التحليلية أن أناقش الرواية من ثلاثة جوانب متداخلة وهي:
التعامل مع الموروث الثقافي. 2- تناقضات المخيم. 3- المرأة عندما تسحقها الذكورة الطاغية.
قد يتسنى لي لاحقاً في مقال آخر تناول الأسلوب والحبكة والحوار والتصعيد الدرامي ورمزية الرواية، لكن أشير هنا في عجالة إلى أن "خالد أبو عجمية" في هذا الإصدار أكد قدراته الروائية من جهة وانطلق بها إلى مساحات أوسع في تجربته الروائية الكلية من جهة أخرى، ليوقع الرواية في المحصلة النهائية بصوت روائي خاص من حيث الأسلوب، لايكرر، ولا يقلد، ولا يحاكي أحداً، وهذه ميزة في منتهى الأهمية بالنسبة إلى الروائي.
التعامل مع الموروث الثقافي:
أن يختار "أبو عجمية" حكاية جبينة ويستدعيها من التراث ويبني عليها روايته، ففي ذلك سعي للربط والتوظيف والترميز، علماً أن هناك فلسفتيين، ويمكن أن نخفف ذلك ونقول أسلوبيين في التعامل مع الموروث الثقافي:
الأول- التماهي مع هذا الموروث تماماً، والالتصاق به، وأخذه كما هو حرفياً، مع أن كثيراً من الأمثال والقصص والعادات التي تناقلت إلينا عبر الأجيال غارقة في السلبي وتدعو إلى الانكفاء والأنانية والنجاة بالنفس والنأي بها والبحث عن الستر بأي ثمن ودون اكتراث بالآخرين..
يقابل ذلك الإيجابي ومآثره وهي بلاشك كثيرة. لا يغادر أنصار هذا الأسلوب الماضي ويفضلون التسمر في دهاليزه، يخشون التغيير والتطوير، ويقدسون النمطية والصنمية، ولا يطورون ولا يتطورون، لأن عجلة التطور الإنساني تتجاوزهم، ولا تلتفت لمن اختاروا البقاء في الهوامش.
الثاني- النظر إلى التراث والتعامل معه من موقع الحاضر، أي من موقع المعاصرة، والأمر هنا يستند إلى إنجازات العصر، ومستوى التفاعل والتحصيل الثقافي والفكري للإنسان المتمعن في التراث الناقد له. إن النظرة التي تنطلق من الحاضر بالضرورة أن تكون نقدية ومقارنة وجدلية واستشرافية..
أكثر من بَحَث وأنجز في هذا الاتجاه مفكرون من لبنان، ومنهم مهدي عامل وحسين مروه، وقد تبنيا نهج قراءة الموروث الثقافي قراءة متأنية نقدية من منظور معاصر.
أقول ذلك لأربط برواية "جبينة أكلها الغول"، لأن الروائي استدعى الحكاية التراثية من موقعه المعاصر، ليناقش ويحلل ويرى بالاستناد إلى معطيات معاشة. كما أن أبا عجمية في روايته قد اقتبس الروح وتناقض مع النهاية المعروفة في التراث لحكاية جبينة التي نجت وانتصرت، بينما "جبينة المعاصرة" راحت ضحية غول تناسل من أغوال وأغوال، والاستدعاء الذكي والتصرف بالحكاية والانطلاق من المعاصرة يحسب تماماً للرواي.
المخيم:
فاض أدبنا في العقود الأخيرة بالإيجابي المطلق، حيث إن الأعمال الأدبية في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات على وجه التحديد صورت تجربة الحركة الأسيرة بأنها مطلقة في كل شيء، مع التطرق أحياناً وباستيحاء لبعض المظاهر السلبية، وتم تناول تجربة الثورة الفلسطينية في بعض الساحات بالتركيز المطلق على البطولة وإغفال ممارسات سلبية، والأمر ذاته ينسحب على المخيم الذي رمزيته ودلالته في الأدب طغت على السلبيات.
في برنامجي التلفزي "عاشق من فلسطين" استضفت من بين ضيوف الحلقات أربعة كتاب ولدوا في مخيم الدهيشة وظلوا على تواصل مع المخيم الذي ولد فيه الروائي خالد أبو عجمية، وعاش مراحل حياته في بيت العائلة وفي أزقة المخيم وحواريه، حيث تباينت النظرة لتجربة المخيم بين الأربعة:
دكتور ناصر اللحام أبرز جوانب سلبية في تجربة المخيم، الفقر، الطفوقة المحرومة المعذبة، البرد، الجوع، وكذلك تنمر الأطفال على بعضهم... الخ
الروائي صالح أبو لبن استدعى أوقات الطفولة المرحة والمنطلقة في المخيم، والذكريات الجميلة، ولم يتطرق للسلبيات، وكأن سنوات الاعتقال بما حملته من حنين قد مسحت وجع المخيم من الذاكرة.
الدكتورة فردوس العيسة طرحت موقفاً وسطاً بين " ناصر اللحام وصالح أبو لبن" مستدعية الإيجابي والسلبي في تجربه المخيم.
الكاتب عيسى قراقع المتنقل دائماً جغرافياً ونفسياً بين مخيمي الدهيشة والعزة، رأى في المخيم بالرغم من المعاناة تربة خصبة للثقافة والإبداع وممارسة الأنشطة والفعاليات.
أما خالد أبو عجمية في روايته وفي النقاشات التي تعود إلى سنوات طوال معه أي إلى 1986- 1987- وتحديداً في معتقل الجنيد، فإن المخيم بالنسبة إليه هو كل ما ذكر في الآراء الأربعة: طفولة قاسية وحرمان، وأناس ينقسمون بين السلبي والإيجابي "خيمة عن خيمة تفرق" على رأي غسان كنفاني، إضافة إلى البعد النضالي والثقافي. وفي روايته تجد في المخيم المرأة المتحدية التي تنتصر على الصعاب والمرأة المضطهدة التي يفترسها الغول .
المرأة:
المرأة في المجتمع الفلسطيني ومنذ القدم تطحنها العادات والتقاليد، وتكبل يديها وروحها بأصفاد دامية، حيث النظرة السائدة المتوارثة بأنها أقل من الرجل إمكانيات وقيمة، لكن في التاريخ الفلسطيني أيضاً نجد المرأة المبادرة المكافحة والمعلمة والأديبة والفلاحة المتوحدة في الأرض ومع الأرض. وبعد انطلاقة الثورة في العام 1965 تصدرت المرأة الصفوف وتبوأت مواقع مهمة، ومن ثم دخلت كل المرافق وأعلى المراتب، ونافست في أول انتخابات رئاسية على الرئاسة، وبالرغم مما تحقق ما زال القسم الأكبر من النساء يعانين القهر والتهميش.
الروائي "أبوعجمية" الذي هو أبن لهذا المجتمع يدرك تماماً معادلة المرأة الفلسطينية، ما يسجل لصالحها، وما يسجل في خانة معاناتها وقهرها، ومن بين ذلك الاضطهاد الجنسي والقتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة، وفي الحالتين فإن الفاعل هو الغول الذي يأكل "جبينة" وكل "جبينة" تقع في حدود سيطرته ونفوذه. ماتت جبينة ولم يمت الغول وإنما ظل شاهراً أنيابه يبحث عن فرائس أخرى. وبهذا دق "أبو عجمية" ناقوس الخطر إبداعياً وبأدواته الفنية التي بدا في روايته متمكناً منها، ليضيف إلى سجل الرواية الفلسطينية رواية ناجحة من حيث الشكل الفني وعميقة في معالجتها وطرحها على مستوى المضمون.